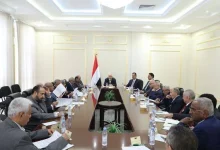برشلونة في عين العاصفة.. تطورات ساخنة في قضية “نيغريرا” | الخليج أونلاين

في الأشهر الأخيرة، تصعد قضية “نيغريرا” لتصبح نقطة اللاعودة في تاريخ كرة القدم الإسبانية، حيث تتقاطع التحقيقات الجنائية مع الجدل الرياضي، ملقية بظلال الشك على نزاهة المنافسة. تتناول هذه القضية المدفوعات التي تلقاها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفني، من نادي برشلونة على مدار 17 عامًا، ما أثار تساؤلات حول إمكانية التأثير على قرارات الحكام لصالح النادي الكتالوني. هذه القضية المعقدة تثير شغور الرأي العام وتلقي بمسؤولية كبيرة على كاهل الجهات القضائية والرياضية.
تطورات قضية نيغريرا: شهادات متضاربة وتساؤلات حول النزاهة
تعود جذور هذه القضية إلى الفترة الممتدة بين عامي 2000 و 2018، حين أبرم نادي برشلونة عقدًا مع نيغريرا مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى 8 ملايين يورو، وُصف بأنه “استشارات تحكيمية”. هذا الوصف الغامض هو ما أشعل فتيل الشكوك حول الهدف الحقيقي من هذه المدفوعات، وما إذا كانت تهدف بالفعل إلى الحصول على مزايا غير عادلة في المباريات. السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه باستمرار: هل كانت هذه الاستشارات مجرد تقارير فنية بريئة، أم كانت وسيلة للتلاعب بنتائج المباريات؟
في الأشهر الأخيرة، اشتعلت القضية مجددًا مع بدء ظهور شهادات مسؤولين سابقين في نادي برشلونة. هذه الشهادات لم تساهم في إزالة الغموض، بل زادت من تعقيد الأمور وتضارب الروايات، مما أثار المزيد من التساؤلات حول حقيقة ما جرى.
شهادة ساندرو روسيل: دفاع عن القانونية ونفي للتأثير
كانت شهادة الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، الأبرز حتى الآن. روسيل، الذي مثل أمام القاضي بصفته مشتبهًا به، دافع بقوة عن قانونية التعاقد مع نيغريرا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي نية للتأثير على قرارات الحكام أو التدخل في عمل اللجنة الفنية.
وأشار روسيل إلى أن علاقته بنيغريرا تعود إلى عام 2003، وأنه كان يعتبره خبيرًا في التحكيم يقدم تقارير وتحليلات فنية مفيدة للنادي. وشدد على أنه لم يكن على علم بقيمة المدفوعات خلال فترة رئاسته، وأنه علم بها لاحقًا من خلال وسائل الإعلام، معتبرًا أن هذه الأرقام لا يمكن أن تكون بمثابة أداة ضغط أو تأثير.
“كنا نفوز في إسبانيا بتأثير لاعبينا، نقطة. ميسي كان يراوغ 4/5 لاعبين ويسجل، أين هو السيد نيغريرا؟” هذا التصريح القوي الذي أدلى به روسيل يلخص موقفه من القضية ويعكس ثقته في قانونية ممارسات النادي.
شهادة خوان لابورتا: تناقضات تثير المزيد من الشكوك
في المقابل، أثارت شهادة الرئيس الحالي لنادي برشلونة، خوان لابورتا، المزيد من الجدل والتناقضات. فقد نفى لابورتا بشكل قاطع لقاءه بنيغريرا، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع إفادة روسيل، التي أكدت وجود علاقة طويلة الأمد بينهما.
كما شدد لابورتا على أن نادي برشلونة لم يكن لديه أي نية للتلاعب بالمنافسة، وأن القضية تهدف إلى “تشويه إنجازات النادي”. هذا التصريح، بالإضافة إلى تناقضاته، أثار انتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام والجماهير، وزاد من الشكوك حول حقيقة ما يجري.
رد فعل ريال مدريد وتصعيد لهجة الإعلام
لم يكتفِ ريال مدريد، المنافس التقليدي لبرشلونة، بالصمت في هذه القضية، بل تصاعدت لهجة انتقاده للنادي الكتالوني. فقد اتهمت قناة ريال مدريد الرسمية خوان لابورتا بالهجوم على النادي الملكي وتضليل الرأي العام، ردًا على انتقاداته الأخيرة.
وذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث اتهمت القناة لابورتا بالإدلاء بشهادة زور أمام القضاء والكذب على المحكمة في أكثر من مناسبة. كما سلطت الضوء على العديد من التناقضات في روايته، بما في ذلك إنكاره معرفته بنيغريرا، ونفي اطلاعه على تقارير الاستشارات التحكيمية، ثم ظهوره الإعلامي مع صناديق قيل إنها تحتوي على هذه التقارير.
مآلات القضية: سيناريوهات محتملة وعقوبات قاسية
في ظل استمرار التحقيقات القضائية، تبقى قضية “نيغريرا” مفتوحة على جميع الاحتمالات. قد تنتهي القضية بتثبيت قانونية التعاقدات وإغلاق الملف، ولكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو توجيه اتهامات رسمية قد تترتب عليها تبعات قانونية ورياضية وخيمة على نادي برشلونة ومسؤوليه السابقين.
ويرى المحلل الرياضي عبد الله طعمة أن احتمالات إدانة برشلونة على الصعيد المحلي قليلة، إلا في حال وجود شهود إثبات حول التلاعب بالنتائج والتأثير على الحكام. ومع ذلك، إذا تمت إدانة برشلونة على المستوى الأوروبي، فقد يواجه عقوبة قاسية تتمثل في حرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة 3 سنوات.
أما على الصعيد المحلي، فقد يتعرض النادي لعقوبات قاسية قد تؤثر على مستقبله لسنوات قادمة. تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه القضية على صورة كرة القدم الإسبانية وتعزيز الشفافية والنزاهة في اللعبة.
مستقبل التحكيم الإسباني والرقابة على الأندية
الجدل الدائر حول قضية نيغريرا لم يقتصر على نادي برشلونة وريال مدريد، بل فتح نقاشًا واسعًا حول آليات الرقابة داخل الأندية الكبرى، وحدود العلاقة بين المؤسسات الرياضية والجهات التحكيمية. كما سلطت الضوء على دور الاتحادات المحلية والدولية في حماية نزاهة المنافسات.
القضية، بلا شك، ستكون لها تداعيات طويلة الأمد على هيكل إدارة كرة القدم الإسبانية، وستدفع إلى إعادة النظر في القواعد واللوائح الخاصة بالتحكيم والعلاقات بين الأندية والجهات الرسمية. يبقى الأمل في أن تخرج هذه القضية بنتائج ملموسة تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في كرة القدم الإسبانية، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الكلمات المفتاحية الرئيسية: قضية نيغريرا، برشلونة، التحكيم الإسباني، خوان لابورتا.
الكلمات المفتاحية الثانوية: ساندرو روسيل، لجنة التحكيم، التلاعب بالنتائج.