كيف حطَّمت غزة النظام العالمي وأسطورة الغرب الإنساني؟

حمل بضع مئات من الشباب اليهود في غيتو وارسو في 19 أبريل/نيسان 1943 كل الأسلحة التي تمكَّنوا من العثور عليها وهاجموا مضطهديهم النازيين. كان معظم اليهود في الغيتو قد رُحِّلوا بالفعل إلى معسكرات الإبادة. كان المقاتلون، كما يتذكر أحد قادتهم ماريك إيدلمان (Marek Edelman)، يسعون إلى الإحساس ببعض الكرامة: «كل ما كان الأمر هو أننا لم نُرد السماح لهم بقتلنا عندما يأتي دورنا. لقد كان مجرد اختيار حول طريقة الموت».
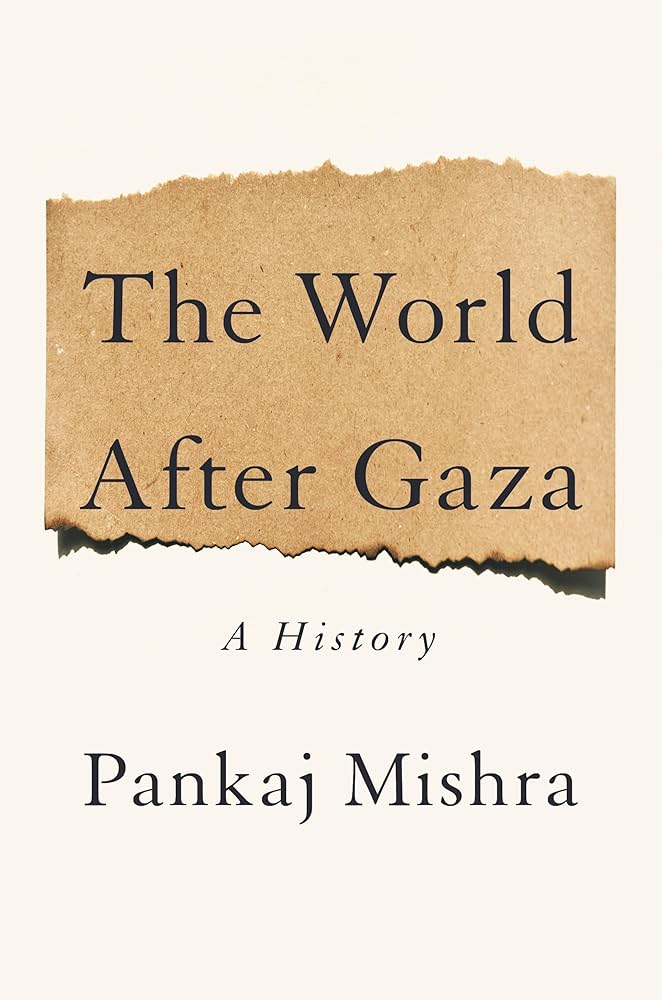
وبعد بضعة أسابيع يائسة، حوصِر المقاومون. وقتل معظمهم. وانتحر بعض من ظلوا على قيد الحياة في اليوم الأخير من الانتفاضة في مخبأ القيادة بينما كان النازيون يضخون الغاز فيه، ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفرار عبر أنابيب الصرف الصحي. وبعد ذلك أحرقَ الجنود الألمان الغيتو، مبنىً تلو الآخر، باستخدام قاذفات اللهب لدفع الناجين إلى الخروج.يتذكر الشاعر البولندي تشيسلاف ميلوش (Czesław Miłosz) أنه سمع في وقت لاحق صراخًا قادمًا من الغيتو «في ليلة هادئة جميلة، ليلة ريفية في ضواحي وارسو»: «أصابنا الصراخ بالقشعريرة. كانت صرخات آلاف الناس الذين يجري قتلهم. سافرت صرخاتهم عبر المساحات الصامتة في المدينة من بين وهج أحمر من النيران، تحت نجوم غير مبالية، إلى الصمت الخيّر للحدائق حيث ينبعث الأكسجين من النباتات بشقِّ الأنفس، كان الهواء عَطِرًا، وشعر إنسانٌ أنه يوجد ما يستحق أن يكون حيًّا لأجله. ثمة شيء قاسٍ على نحو خاصٍ في هدأةِ هذا الليل، الذي ضربت جمالياته وجرائمه الإنسانية القلب في آنٍ واحد. لم ننظر في عيون بعضنا البعض».
في قصيدة كتبها ميلوش في وارسو المحتلة بعنوان «حقل الأزهار» (Campo dei Fiori)، يستحضر لعبة دوامة الخيل (الكارسول أو merry-go-round) بجوار جدار الغيتو، حيث يتحرك ركّاب اللعبة نحو السماء عبر دخان الجثث، وحيثُ تُغْرِق ضحكاتهم المرحة صرخات الألم واليأس. عاش ميلوش في بيركلي بولاية كاليفورنيا، بينما كان الجيش الأميركي يقصف ويقتل مئات الآلاف من الفيتناميين، وهي فظائع قارنها بجرائم أدولف هتلر وجوزيف ستالين، فعِرف الشَّاعِر مرة أخرى معنى التواطؤ المخزي مع الوحشية المتطرفة. وكتبَ: «إذا كنا قادرين على التعاطف، وفي نفس الوقت عاجزين، فإننا نعيش في حالة من السخط المُفرط».
لقد تدمير إسرائيل لقطاع غزة، بدعم من الديمقراطيات الغربية، هذا المحنة النفسية لعدة أشهر على ملايين البشر —شهودٌ غير طوعيين على عمل من أعمال الشر السياسي — الذين سمحوا لأنفسهم بين الحين والآخر بالتفكير في أنه يوجد ما يستحق أن يكونوا أحياء لأجله، ثم سمعوا صراخ أمٍّ تشاهد ابنتها تحترقُ حتَّى الموت في مدرسة أخرى قَصفتْهَا إسرائيل.

تركت المحرقة ندوبًا عميقة على عدة أجيال يهودية. وشهد اليهود الإسرائيليون في عام 1948 ميلاد دولتهم الوطنية باعتبارها مسألة حياة أو موت، ثم مرة أخرى في عامي 1967 و1973 وسط خطاب التدمير من جانب أعدائهم العرب. بالنسبة للعديد من اليهود الذين نشأوا وهم يدركون أن اليهود في أوروبا قد قُضي عليهم بالكامل تقريبًا دون أي سبب غير كونهم يهودًا، فإن العالم لا يمكن أن يبدو إلا هشًا. وكان 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من بين هذه الأحداث التي شهدت مجازًا واحتجازًا للرهائن، على يد حماس وجماعات فلسطينية أخرى، مما أعاد إشعال المخاوف من وقوع هولوكوستٍ آخر.

غير أنه كان واضحًا منذ البداية أن القيادة الإسرائيلية الأكثر تعصبًا في التاريخ لن تتردد في استغلال الشعور الدائم بالانتهاك والحزن والرعب. لقد ادّعى زعماء إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد حماس، ولكن كما اعترف عمر بارتوف (Omer Bartov)، المؤرخ الكبير للهولوكوست، في أغسطس/آب 2024، فإنهم سعوا منذ البداية إلى «جعل قطاع غزة بأكمله غير صالح للسكن، وإضعاف سكانه إلى درجة تجعلهم إما يموتون أو يسعون إلى استنفاد الخيارات الممكنة للفرار من المنطقة». وهكذا، على مدى أشهر بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، شهد المليارات من البشر هجومًا غير عادي على غزة، وكان ضحاياه، كما عبَّرت بلين ني غرالاي (Blinne Ni Ghralaigh)، المحامية الأيرلندية التي رافعت نيابة عن جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، «يبثّون تدميرهم على الهواءِ مباشرةً على أمل يائسٍ، وعبثي حتى الآن، في أن يفعل العالم شيئًا».
ولم يفعل العالم، أو بالأحرى الغرب، شيئًا. كان ماريك إيدلمان خلف جدران غيتو وارسو «خائفًا للغاية» من أن «أحدًا في العالم لن يُلاحظ شيئًا»، وأنّه «لن يخرج [من الغيتو] أي شيء، ولا أي رسالة عنّا، إلى العالم على الإطلاق». والحالُ لم يكن كذلك في غزة، حيث تنبأ الضحايا بمقتلهم على وسائل الإعلام الرقمية قبل ساعات من إعدامهم، وقام قاتلوهم ببث أفعالهم بكل سهولة على تيك توك. بيد أن عمليات التطهير العرقي التي بُثَّت على الهواء مباشرة كانت تُطمس يوميًا من قبل أدوات الهيمنة العسكرية والثقافية الغربية: من زعماء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الذين هاجموا المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى محرري صحيفة نيويورك تايمز الذين أصدروا تعليمات لموظفيهم، في مذكرة داخلية، لتجنب استخدام مصطلحات «مخيمات اللاجئين»، و«الأراضي المحتلة»، و«التطهير العرقي».
مع مرور الأيام، وبينما نواصل حياتنا، صار وعينا مسمومًا بأن مئات الناس العاديين، كانوا يُقتلون أو يُجبرون على أن يشهدوا مقتل أطفالهم. وقد أُتبعت المناشدات التي أطلقها الناس في قطاع غزّة، والذين كانوا في أغلب الأحيان من الكُتّاب والصحفيين المعروفين، والذين حذروا من أنهم وأحبائهم على وشك أن يُقتلوا، بأنباءٍ عن مقتلهم، وهو ما يفاقم الإذلال الناجم عن العجز الجسدي والسياسي. أولئك الذين دفعهم شعورهم بالذنب بسبب التورط العاجز إلى قراءة وجه الرئيس الأميركي جو بايدن بحثًا عن أي علامة على الرحمة أو أي علامة على نهاية إراقة الدماء، وجدوا صلابة ناعمة مخيفة، لم يكسرها سوى ابتسامة عصبية عندما تفوه بأكاذيب إسرائيلية مفادها أن الفلسطينيين قطعوا رؤوس أطفال إسرائيليين. تحطمت بوحشية كل الآمال العادلة التي أثارها هذا القرار أو ذاك للأمم المتحدة، والنداءات المحمومة من المنظمات غير الحكومية الإنسانية، والقيود من جانب هيئة المحلفين في لاهاي، واستبدال بايدن في اللحظة الأخيرة كمرشح رئاسي.
بحلول أواخر عام 2024، كان العديد من الناس الذين يعيشون بعيدًا جدًا عن مجال القتل في قطاع غزّة يشعرون —على مسافة بعيدة، ولكنهم يشعرون— بأنهم قد جُرُّوا إلى مشهد ملحمي من البؤس والفشل والألم والإرهاق. قد يبدو هذا بمثابة عبء عاطفي مبالغ فيه بين المتفرجين فقط. ولكن الصدمة والغضب اللذين أثارهما كشف بيكاسو عن لوحة «غرنيكا»، التي تصور خيولها وبشرها وهم يصرخون في أثناء تعرضهم للقتل من السماء، كانت نتيجة صورة واحدة من غزة لأب يحمل جثة طفله مقطوعة الرأس.
سوف الحرب تصبح في نهاية المطاف شيئًا من الماضي، وربما يسحق الزمن كومة أهوالها الشاهقة. ولكن علامات الكارثة ستبقى في قطاع غزّة لعقود من الزمن: في أجساد الجرحى، والأطفال الأيتام، وأنقاض مدنها، والمشردين، وفي الحضور الشامل والوعي بالحزن الجماعي. وأولئك الذين شاهدوا من بعيد بلا حول ولا قوة قتل وتشويه عشرات الآلاف على شريط ساحلي ضيق، وشهدوا أيضا تصفيق الأقوياء أو لامبالاتهم، سوف يعيشون بجرح داخلي وصدمة لن تزول لسنوات.
إن النزاع حول كيفية الإشارة إلى العنف الإسرائيلي —دفاع مشروع عن النفس أو حرب عادلة في ظروف حضرية صعبة أو تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية— لن يُسوّى أبدًا. ولكن ليس من الصعب أن نتعرف في كوكبة الانتهاكات الأخلاقية والقانونية الإسرائيلية على علامات الفظاعة النهائية: القرارات الصريحة والروتينية من جانب القادة الإسرائيليين بالقضاء على غزة، وموافقتهم الضمنية من جانب الجمهور الذي يندد بالانتقام غير الكافي من جانب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزّة، وتعريفهم للضحايا باعتبارهم شرًا لا يمكن التوفيق بينه وبين غيرهم، وحقيقة أن معظم الضحايا كانوا أبرياء تمامًا، وكثير منهم من النساء والأطفال، وحجم الدمار، الذي كان أكبر نسبيًا من ذلك الذي حققه قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ووتيرة عمليات القتل، وملء المقابر الجماعية في جميع أنحاء قطاع غزّة، وأساليبها، غير الشخصية الشريرة (التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي) والشخصية (تقارير عن قناصة يطلقون النار على الأطفال في الرأس، في كثير من الأحيان مرتين)، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والدواء، والعصي المعدنية الساخنة التي يتم إدخالها في مستقيم السجناء العراة، وتدمير المدارس والجامعات والمتاحف والكنائس والمساجد، وحتى المقابر. إن الشر الذي يجسده جنود الجيش الإسرائيلي وهم يرقصون في ملابس النساء الفلسطينيات القتيلات أو الفارّات من القتل، وشعبية مثل هذا النوع من المحتوى الترفيهي على تطبيق تيك توك في إسرائيل، والإعدام الدقيق للصحفيين في القطاع الذين يوثقون إبادة شعبهم.
ومن المؤكد أن القسوة التي تصاحب المذابح على نطاق واسعٍ ليست غير مسبوقة. منذ عقود من الزمن، أصبحت المحرقة بمثابة معيارٍ للشرّ البشري. إن المدى الذي يحدده الناس على هذا النحو، ويَعِدون ببذل كل ما في وسعهم لمكافحة معاداة السامية يعتبر، في الغرب، مقياسًا لمدى حضارتهم. لكن العديد من الضمائر تعرضت للتشويه أو الموت على مر السنين التي مُحي فيها يهود أوروبا. لقد انضمت أجزاء كثيرة من أوروبا غير اليهودية، وفي كثير من الأحيان بحماسة، إلى الهجوم النازي على اليهود، وحتى الأخبار المتعلقة بمقتلهم الجماعي قوبلت بالتشكك واللامبالاة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة. إن التقارير عن الفظائع المرتكبة ضد اليهود، والتي سجلها جورج أورويل في أواخر فبراير/شباط 1944، كانت ترتد من الوعي «مثل [ارتدادِ] حبات البازلاء عن خوذة فولاذية». لقد رفض الزعماء الغربيون قبول أعداد كبيرة من اللاجئين اليهود لسنوات بعد الكشف عن الجرائم النازية. وبعدها، تجوهلت معاناة اليهود وقمعت. وفي الوقت نفسه، ورغم أن ألمانيا الغربية لم تتحرر بعد من النازية، فقد حصلت على تبرئة رخيصة من القوى الغربية لتجنيدها في الحرب الباردة ضد الشيوعية السوفييتية.
قوضت هذه الأحداث، التي حصلت في الذاكرة الحية، الافتراض الأساسي لكل من التقاليد الدينية والتنوير العلماني: وهو أن البشر يتمتعون بطبيعة «أخلاقية» أساسية. والآن أصبح الشك المنتشر على نطاق واسع بأنهم لا ليسوا أخلاقيين بالضرورة. لقد شهد العديد من الناس عن كثب الموت والتشويه في ظل أنظمة القسوة والجبن والرقابة، وهم يدركون الآن بصدمة أن كل شيء ممكن، وأن تذكر الفظائع الماضية لا يُعدّ ضمانة ضد تكرارها في الحاضر، وأن أسس القانون الدولي والأخلاق ليست آمنة على الإطلاق.
لقد وقعت الكثير من الأحداث في العالم في السنوات الأخيرة: كوارث طبيعية وانهيارات مالية وزلازل سياسية وجائحة عالمية وحروب غزو وانتقام. ولكن لا توجد كارثة تقارن بكارثة غزة —لم يترك فينا شيءٌ مثل هذا القدر الهائل من الحزن والحيرة والضمير المؤلم. لم يقدم أي شيء مثل هذا القدر من الأدلة المخزية على افتقارنا إلى العاطفة والسخط وضيق نظرتنا وضعف فكرنا. لقد دُفِعَ جيلٌ كاملٌ من الشباب في الغرب إلى مرحلة الرشد الأخلاقي؛ بسبب أقوال وأفعال (وتقاعس) كِبارهم في السياسة والصحافة، وأُجبروا على التعامل، بمفردهم تقريبًا، مع الأعمال الوحشية التي دعمتها أغنى وأقوى الديمقراطيات في العالم.
لقد كان حقد بايدن العنيد وقسوته تجاه الفلسطينيين مجرد واحد من العديد من الألغاز المروعة التي طرحها السياسيون والصحفيون الغربيون. كان من السهل على الزعماء الغربيين الامتناع عن تقديم الدعم غير المشروط لنظام متطرف في إسرائيل مع الاعتراف في الوقت نفسه بضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتقديمهم إلى العدالة. ولكن لماذا زعم بايدن مرارًا وتكرارًا أنه رأى مقاطع فيديو لفظائع لم تُرتكبْ؟ لماذا أكَّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، أن إسرائيل «لها الحق» في قطعِ الكهرباء والمياه عن الفلسطينيين، ومعاقبة أولئك في حزب العمال الذين يطالبون بوقف إطلاق النار؟ ولماذا سارع يورغن هابرماس، بطل التنوير الغربي البليغ، إلى الدفاع عن مرتكبي التطهير العرقي الظّاهرين؟
وما الذي دفع مجلة أتلانتيك، إحدى أقدم الدوريات في الولايات المتحدة، إلى نشر مقال يزعم، بعد مقتل نحو 8 آلاف طفل في غزة، أن «قتل الأطفال أمر ممكن قانونيًا»؟ وما الذي يفسر اللجوء إلى صيغة المبني للمجهول في وسائل الإعلام الغربية السائدة أثناء الإبلاغ عن الفظائع الإسرائيلية، الأمر الذي جعل من الصعب معرفة من يفعل ماذا، ومن هو المفعول بهِ، وفي ظل أي ظروف (مثال: «الموت الوحيد لرجل من غزة مصاب بمتلازمة داون» كان عنوان تقرير لبي بي سي عن جنود إسرائيليين أطلقوا كلبًا هجوميًا على فلسطيني معاق)؟ لماذا ساهم مليارديرات الولايات المتحدة في تعزيز حملات القمع القاسية للمتظاهرين في الحرم الجامعي؟ لماذا طُرِدَ الأكاديميون والصحفيون، ومُنِع الفنانون والمفكرون من العمل، ولماذا مُنع الشباب من العمل لمجرد ظهورهم وكأنهم يتحدون الإجماع المؤيد لإسرائيل؟ لماذا استبْعَد الغربُ الفلسطينيين على نحوٍ واضح من مجتمع الالتزام والمسؤولية الإنسانية، بينما كان يدافع عن الأوكرانيين ويحميهم من هجوم سامٍّ؟
وبغض النظر عن الكيفية التي نتعامل بها مع هذه الأسئلة، فإنها تجبرنا على النظر مباشرة إلى الظاهرة التي نواجهها: الكارثة التي تسببت فيها الديمقراطيات الغربية بصورة مشتركة، والتي دمرت الوهم الضروري الذي نشأ بعد هزيمة الفاشية في عام 1945 حول إنسانية مشتركة يدعمها احترام حقوق الإنسان والحدّ الأدنى من المعايير القانونية والسياسية.
* هذا المقال مقتبس من كتاب تاريخ العالم بعد غزّة (The World After Gaza: A History) بقلم بانكاج ميشرا.
* المقال لا يعبّر بالضرورة عن رأي موقع عرب48.
المصدر: عرب 48




